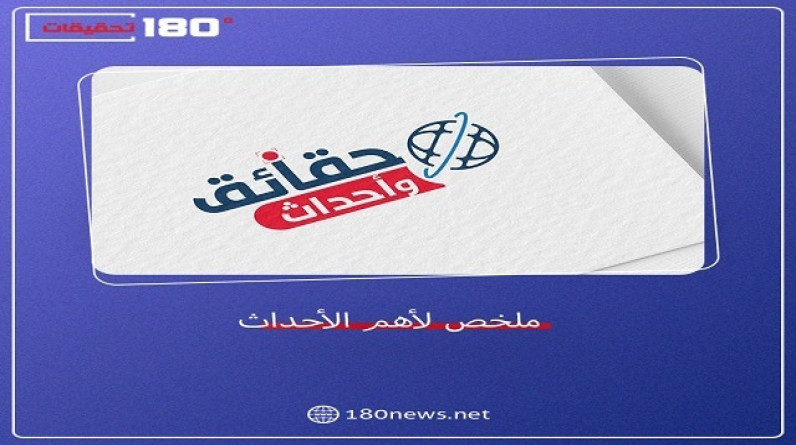-
℃ 11 تركيا
-
25 أغسطس 2025
حوارات الخبير محند أمقران.. الدكتور خالد فضيل: لا مناص من مقاربة تشاركية جامعة للكفاءة العلمية و الخبرة الميدانية للتهيئة العمرانية وتسيير المدن وتنشيط الأقاليم
حوارات الخبير محند أمقران.. الدكتور خالد فضيل: لا مناص من مقاربة تشاركية جامعة للكفاءة العلمية و الخبرة الميدانية للتهيئة العمرانية وتسيير المدن وتنشيط الأقاليم
-
24 أغسطس 2025, 9:32:11 م
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
حوارات الخبير محند أمقران.. الدكتور خالد فضيل: لا مناص من مقاربة تشاركية جامعة للكفاءة العلمية والخبرة الميدانية
السيد خالد فضيل، دكتور وأستاذ بجامعة قسنطينة الجزائرية ، مناضل جمعي ورئيس جمعية اوكسيجون ،أي اوكسجين الشباب أن صح التعبير.
شكرا لإتاحة الفرصة لمتابعي موقع تحقيقات لمعرفة مساركم و الإطلاع أكثر على جمعيتكم.
▪︎بداية هل لكم أن تقدموا لمساركم العلمي والنضالي المتناغم والمترابط؟
أشكركم على الاستضافة وعلى إتاحة هذه الفرصة للتواصل مع قرائكم ومتابعيكم.
مساري الأكاديمي بدأ من شغف مبكر بقضايا المدينة والبيئة، وهو ما دفعني إلى اختيار تخصص *تسيير التقنيات الحضرية* بجامعة منتوري بقسنطينة، حيث حصلت على شهادة مهندس دولة سنة 2010.
بعد ذلك، واصلت مساري العلمي من خلال التعمق في الدراسات العليا، باحثًا في مجالات العمران المستدام والحوكمة البيئية، بعد اطروحة الماجيستر في نفس الجامعة، لأنني كنت مقتنعًا منذ البداية أن التنمية الحضرية لا يمكن أن تنجح دون مراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية.
لكنني لم أكتفِ بالبحث العلمي داخل أسوار الجامعة، لأنني أدركت أن المشاكل البيئية والمواطناتية التي تواجهها الجزائر ليست فقط تقنية، بل ثقافية وسلوكية أيضًا. لذلك، قررت أن أنخرط في العمل الميداني من خلال تأسيس جمعية *Oxyjeunes (أوكسيجون درقينة سنة 2016)، التي تُعنى بالتحسيس والتوعية و التكوين، وخلق فضاءات للشباب تُمكّنهم من التعبير والمشاركة في الحلول البيئية.
هذه التجربة النضالية جاءت من قناعة أن حماية البيئة مسؤولية جماعية تبدأ من المواطن، وأن التغيير لا يحدث إلا عندما نمنح الشباب الثقة والوسائل ليكونوا جزءًا من الحل.
اليوم أحاول المزج بين جانبي المسار: الأكاديمي، حيث أواصل التدريس والبحث في جامعة قسنطينة 3، ومخبر الاستشراف الجغرافي، البيئة والتنمية ، حول قضايا العمران والحوكمة البيئية، والجمعوي، حيث نعمل عبر الجمعية على مشاريع ملموسة في الميدان، من حملات توعية إلى مبادرات للحد من التلوث وتعزيز الثقافة البيئية.
ما يجمع بينهما هو رؤية واحدة: أن نبني مجتمعًا واعيًا بأن البيئة ليست ترفًا بل شرطًا أساسيًا للتنمية والحياة الكريمة."
▪︎ماهي حدود الاستجابة الميدانية لنتائج أبحاثكم و دراساتكم فيما يخص التهيئة العمرانية و رصد المخاطر من طرف الهيئات الوصية ؟ و هل هناك تعاون حقيقي بين الجامعة و الجماعة المحلية و مراكز صناعة القرار في الاستشراف و الرصد الخاص بالكوارث الطبيعية مثلا؟
شكرًا على السؤال المهم، لأنه يطرح إشكالية محورية في العلاقة بين البحث العلمي وصناعة القرار. في الواقع، حدود الاستجابة الميدانية لنتائج أبحاثنا في مجال التهيئة العمرانية ورصد المخاطر لا تزال ضيقة مقارنة بالتحديات المطروحة على أرض الواقع.
لدينا في الجزائر إنتاج علمي معتبر، سواء في مجال الدراسات الحضرية أو في تقييم المخاطر الطبيعية مثل الانزلاقات الأرضية، الفيضانات، وحرائق الغابات وحتى هشاشة البنية التحتية. ولكن الإشكال الأساسي يكمن في غياب آليات واضحة لترجمة هذه الدراسات إلى سياسات فعلية.
غالبًا ما تظل التوصيات حبيسة التقارير، في حين نحتاج إلى إدماجها في القرارات الميدانية.
على سبيل المثال، *في فيضانات قسنطينة عام 2020، كانت هناك تقارير علمية سابقة حذرت من اختناق المجاري المائية بفعل التوسع العمراني العشوائي. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية في الوقت المناسب، وهو ما أدى إلى خسائر بشرية ومادية. نفس الأمر ينطبق على بعض أحياء بجاية التي شهدت **انزلاقات أرضية متكررة*، رغم وجود دراسات تؤكد هشاشة التربة في هذه المناطق.
من جهة أخرى، هناك بعض الخطوات الإيجابية مثل إدراج المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية PDAU ومخططات شغل الاراضي POS**، لكنها تبقى في كثير من الأحيان مجرد وثائق شكلية لا يتم تطبيقها ميدانيًا كما ينبغي، أو يتم تجاوزها بفعل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية.
الحل في تقديري هو اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية، بحيث يتم إشراك الباحثين والخبراء في جميع مراحل القرار، من التشخيص إلى التنفيذ. كما يجب أن يكون هناك *إطار تشريعي يلزم الهيئات الوصية باعتماد الدراسات العلمية، وليس الاكتفاء باستشارات شكلية. إضافة إلى ذلك، نحن بحاجة إلى نظام معلومات حضري موحّد يتيح تبادل البيانات بين الجامعة، البلديات، ومصالح الحماية المدنية، حتى تكون التدخلات مبنية على معطيات دقيقة وحديثة.
▪︎التهيئة العمرانية مرتبطة بالجغرافيا والسياقات الثقافية و الاجتماعية للساكنة .
▪︎كيف تقيم مستوى التهيئة العمرانية بالجزائر ؟
سؤال في غاية الأهمية، لأنه يمس جوهر التهيئة العمرانية بوصفها ليست مجرد عملية تقنية، بل مشروعًا اجتماعيًا وثقافيًا متكاملًا. التهيئة في أي بلد ينبغي أن تعكس هوية المكان، تراعي الجغرافيا، وتستجيب لاحتياجات المجتمع، وإلا تصبح مجرد نسخ ميكانيكي لنماذج مستوردة.
*أهم الملاحظات على الوضع الحالي:
1. ضعف مراعاة الخصوصيات المحلية: في كثير من المدن، نرى اعتماد نماذج عمرانية لا تتناسب مع الثقافة المحلية ولا مع المناخ. مثال ذلك توسع العمارات السكنية في مناطق ريفية، وهو ما أدى إلى فقدان النسيج الإجتماعي التقليدي.
2. غياب التوازن بين الشمال والجنوب: الجنوب الجزائري، رغم إمكانياته الجغرافية، لم يستفد من مشاريع تهيئة متكاملة تراعي البيئة الصحراوية. غالبًا يتم نقل نماذج الشمال إلى الجنوب، مما يخلق مشكلات في التكيف البيئي.
3. إشكالية التوسع العشوائي: حوالي 30% من العمران في بعض المدن الكبرى هو غير مهيكل، مثل ضواحي العاصمة أو قسنطينة، حيث غابت شبكات الطرق والخدمات الأساسية.
4. الهشاشة أمام المخاطر الطبيعية: التهيئة الحالية لم تدمج بشكل كافٍ سياسات الوقاية من الفيضانات والانزلاقات الأرضية، رغم أننا نملك قاعدة بيانات علمية قوية في هذا المجال.
لكن بالمقابل، هناك بعض النقاط الإيجابية: بداية التحول نحو المدن الذكية والرقمنة في بعض المشاريع.، إدراج البعد البيئي في بعض المخططات الجديدة، وإن كان ذلك لا يزال محتشمًا.
في الأخير نقول، مستوى التهيئة في الجزائر يمكن وصفه بأنه تخطيطي أكثر منه استراتيجي. نحتاج إلى الانتقال من منطق تسيير الأزمة إلى منطق استشراف المستقبل، مع تعزيز البعد الثقافي والبيئي.
▪︎العنف الإجتماعي مرتبط أيما ارتباط بالعمران وتسييره و نحن نلاحظ ازدياد درجة العنف الحضري إلى ماذا يرجع ذلك و ماهي الحلول و التوصيات التي تقترحونها؟
صحيح، العنف الحضري ليس مجرد ظاهرة اجتماعية معزولة، بل هو نتاج تفاعل بين البنية العمرانية والسياقات الاقتصادية والثقافية. العنف الحضري ينتج أساسا من الكتل الاسمنتية المفرغة من أي روح أو هوية والتي تسمى مدنا ومراكز حضرية، المدن اليوم اصبحت اقطاب للرعب والمجهول بعيداً جداًّ عن البعد الإنساني في التصميم و الانجاز والتهيئة الخارجية، واجهات غير مكتملة، عمران عشوائي ، أوساخ ونفايات في كل مكان، مياه الصرف الصحي على الأرصفة والطرقات، شرفات غير متجانسة، أسلاك في كل مكان، غياب مساحات اللعب، و مساحات ركن السيارات، .. منتجات تجارية على الأرصفة، سلالم عمارات مليئة بالاوساخ، والعفن، وبول العابرين.... كلها مظاهر تنتج العنف والتمرد والتطرف... للتفصيل عندما نتحدث عن الجزائر، نجد أن ازدياد حدة العنف الحضري له علاقة مباشرة بعدة عوامل:
أولاً الأسباب الرئيسية
1. غياب العدالة المكانية والمجالية : التوسع العشوائي ونقص المرافق العامة (مساحات خضراء، مراكز ثقافية، أماكن ترفيه) جعل الأحياء مجرد كتل إسمنتية، وهو ما يولد الإحباط والضغط النفسي.
2. الاختلال في توزيع الخدمات: في أحياء كثيرة، نجد نقصًا في النقل، المدارس، والمراكز الصحية، مما يعمق الإحساس بالتهميش. ثم العنف ..
3. ضعف التصميم الحضري وغياب الهوية العمرانية: كثير من المدن الجزائرية توسعت بشكل غير مهيكل، مما خلق أحياء مكتظة، ضيقة، ومغلقة، وهو ما يزيد فرص الاحتكاك والنزاعات.
4. غياب الثقافة المدنية والمواطنة في الفضاء العام: ضعف التربية على المواطنة والاستخدام المشترك للمساحات يولد صراعات على الموارد القليلة المتاحة.
ثانيًا: الروابط مع العنف الحضري
الأبحاث العالمية والمحلية من مدرسة شيكاغو إلى آخر البحوث في العصر الحديث، تبيّن أن كلما فقدت المدينة بعدها الإنساني والاجتماعي، ارتفعت نسب النزاعات. وهذا ما نراه في بعض الأحياء السكنية الجديدة التي تفتقر لهوية عمرانية وروابط اجتماعية، فتحولت إلى بيئات مغلقة ومنعزلة.
ثالثًا: الحلول والتوصيات، حسب تجربتي والدراسات التي قمت بها طيلة مشواري، وكذا البحوث التي اشرفت عليها في طور الماستر..
1. إعادة الاعتبار للمساحات العامة المشتركة: الحدائق، المراكز الثقافية، والملاعب الشعبية ليست كماليات، بل أدوات لامتصاص التوتر.
2. التخطيط التشاركي: أو بصيغة أوضح "العمران من الشعب وإلى الشعب" إشراك السكان في رسم معالم الحي يعطيهم إحساسًا بالانتماء والمسؤولية، ما يقلل السلوك العدواني.
3. توزيع عادل للخدمات: تقليص الفوارق بين الأحياء عبر سياسة حضرية عادلة، خاصة في المدن الكبرى.
4. إدماج البعد الاجتماعي في سياسات التهيئة : لا يجب أن يقتصر العمران على الإسمنت، بل يجب أن يراعي النسيج الاجتماعي ويعيد إنتاجه.
5. برامج توعية حضرية: إدخال التربية الحضرية في المدارس، وتنظيم حملات توعية في الأحياء. وزيادة اهتمام الإعلام بهذا الموضوع.
في الأخير نقول أن العنف الحضري ليس قدراً حتميًا، بل انعكاس لسياسات حضرية تحتاج إلى إصلاح. عندما نمنح الناس فضاءات للتنفس، وخدمات متكافئة، وأحياءً مصممة للعيش المشترك، نقلل حدة النزاعات ونعيد للمدينة بعدها الإنساني.

 أحد, 24 أغسطس 2025
أحد, 24 أغسطس 2025 
 أحد, 24 أغسطس 2025
أحد, 24 أغسطس 2025 
 جمعة, 08 أكتوبر 2021
جمعة, 08 أكتوبر 2021 
 ثلاثاء, 22 يونيو 2021
ثلاثاء, 22 يونيو 2021 
 سبت, 18 سبتمبر 2021
سبت, 18 سبتمبر 2021 
 جمعة, 01 أكتوبر 2021
جمعة, 01 أكتوبر 2021 
 ثلاثاء, 02 نوفمبر 2021
ثلاثاء, 02 نوفمبر 2021 
 ثلاثاء, 05 أغسطس 2025
ثلاثاء, 05 أغسطس 2025 
 اثنين, 09 يونيو 2025
اثنين, 09 يونيو 2025 
 خميس, 05 يونيو 2025
خميس, 05 يونيو 2025 




 تابعنا على تليجرام
تابعنا على تليجرام  تابعنا على واتساب
تابعنا على واتساب