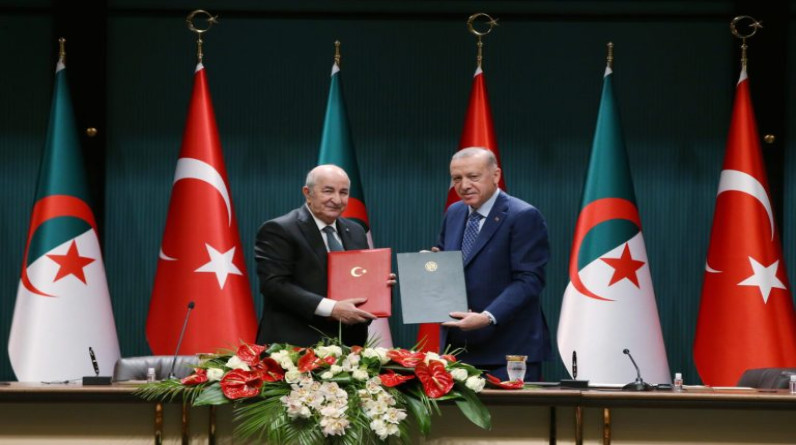-
℃ 11 تركيا
-
6 سبتمبر 2025
ليلى الدعمي: رحلة بين الفنون والآداب والتراث من تونس العتيقة إلى الإبداع العالمي (الجزء الأول)
حوارات الخبير محند أمقران
ليلى الدعمي: رحلة بين الفنون والآداب والتراث من تونس العتيقة إلى الإبداع العالمي (الجزء الأول)
-
6 سبتمبر 2025, 3:44:20 م
-
 428
428 - تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
ليلى الدعمي
من تكون الأديبة ليلى الدّعمي؟
هي كاتبة تونسية متميزة بنشاطها الأدبي و المهني و ملتزمة مدنيا . من الكتابة للاهتمام بالتراث الثقافي و تثمينه و المساهمة في التنشيط الثقافي في تونس . الأدبية ليلى الدعمي ،تصنع تميزا على عدة مستويات، فليلى الدّعمي مهندسة فضاء داخلي خبيرة في التّراث، مولودة بمدينة تونس العتيقة أصيلة مدينة بنبلة من ولاية المنستير، متحصّلة على شهادة الباكالوريا آداب، والأستاذيّة في مجال علوم وتقنيّات الفنون، وشهادة الدّراسات المعمّقة التّراث والآثار. تابعت مرحلة الدّكتوراه في التّراث والآثار بالشّراكة مع المدرسة التطبيقيّة للدّراسات العليا بباريس Paris Dauphine.، ، كان لي معها هذا الحوار الدسم .
تلقّت الكاتبة تكوينا متعدّد الاختصاصات حيث زاولت دراسات التّأهيل للبحث العلمي CAR، في مجال الفنون التشكيليّة، ودراسات التخصّص DESS في التهيئة العمرانيّة والتّعمير، ودرست تاريخ الفنّ الحديث والوسائط الثقافيّة الحديثة وتقنيات التّصميم والإشهار الرّقمي PAO، وأحرزت على الدّرجة السّادسة في الإنقليزيّة وعلى شهادة في الأنفوغرافيا.
امتهنت في بداياتها تدريس الفنون التّشكيليّة في المعاهد الثّانويّة وتصميم الأثاث قبل أن تلتحق بوزارة الثّقافة مكلّفة بالتهيئة وتوظيب المتاحف. ودرّست تاريخ العمارة الإسلاميّة بالعالي لمهن التّراث، وتاريخ فنون التّصميم بالمعهد العالي الكندي للتّصميم والفنون Collège Lassalle. اهتمّت بالبحث العلمي في مجال التّراث والآثار وتخصّصت في ميدان التّراث غير المادّي والسّياحة الثقافيّة حيث أحرزت على شهادة مكوّن للمكوّنين ثمّ شهادة تكوين في قانون اللّزمات في التّراث، وفي حوكمة المؤسّسات.
راكمت، تجارب مهنيّة عديدة ومارست العمل الميداني مع الخواصّ وفي الوظيفة العموميّة سواء في تصميم وصنع الأثاث، أو إنجاز المعارض الوثائقيّة، وتوضيب وتّهيئة المتاحف (برصيد أربعة متاحف)، وتصميم اللّوحات التشويريّة والعلامات التوجيهيّة، وتهيئة مسالك الزّيارة بالمواقع الأثريّة والمعالم التّاريخيّة، وتهيئة المسالك السّياحيّة والثقافيّة، وتصميم المنتوجات الثقافيّة والتّحف التذكاريّة المستوحاة من التّراث، أو تصوّرات لأساليب تثمين التّراث وبلورة مسالك التّراث غير المادّي وإعداد مشاريع الاستثمار الثّقافي وإعادة توظيف المعالم التّاريخيّة.
عضوة باللّجنة الوطنيّة للتّاريخ العسكري والمجلس العلمي لمتحف الفنون الحديثة والمعاصرة، والمجلس الفنّي لمؤسّسة المهرجانات والتّظاهرات الفنيّة، عضوة سابقة لسنوات في لجنة التّحكيم الوطنيّة للخمسة الذهبيّة ولجان المسابقات الوطنيّة في الصّناعات التقليديّة، نائبة رئيس اللّجنة الوطنيّة للمجلس الدّولي للمعالم والمواقعICOMOS ، نائبة رئيس اللّجنة الوطنيّة للمجلس الدّولي للمتاحف ICOM، ونائبة رئيس الهيئة المديرة لنادي القصّة »أبو القاسم الشّابي«.
- هنيئا لك إصدار كتابك الجديد، هلاّ تحدّثينا عن جديدك.
شكرا على التّهنئة بالإصدار الذي يعكس تجربة مغايرة تتمثّل في ترجمة المجموعة القصصيّة »شجرة الأحلام العالية« للكاتب الأستاذ الجامعي المنذر المرزوقي، تحت عنوان « L’arbre fantasmagorique et les rêves sublimes ». بالنّسبة للجديد بعد إصدار المجموعة القصصيّة الأولى »عرس القمر« سنة 2022، أنا بصدد الاشتغال على مجموعة قصصيّة ثانية تحت عنوان »علّيسة بيننا«. وهي الآن في مرحلة المراجعة النهائيّة ونأمل أن تجهز للنّشر خلال الثّلاثي الأخير لسنة 2025 تزامنا مع بداية الموسم الثّقافي المقبل.
أمّا عن المشاريع المستقبليّة، فأنا أسعى مع بعض الأدباء الأصدقاء، إلى مزيد تطوير قدراتنا بتنويع التّجارب، والطّموح إلى إصدار مجموعة مشتركة أو أكثر. لكنّي أفكّر بجديّة في الإثراء بشكل أوسع باللّغتين العربيّة والفرنسيّة، لا فقط في عالم القصّ والتّرجمة، بل أيضا في مجال البحث العلمي في التّراث والآثار بتوظيف اختصاصي الأكاديمي، لإعداد دراسات علميّة ومقالات حول الموروث الحضاري والمخزون الثّقافي والمعمار التّاريخي، ولما لا بلورة تصّورات مبتكرة لأساليب تثمين التّراث المادّي وغير المادّي. وإن سمحت لنا الحياة بذلك قد نخوض تجارب أخرى في عالم القصّ للأطفال واليافعين.
- كيف كانت بداياتك في الكتابة؟
كنت قد نشأت في بيئة تقليديّة بسيطة تهيب بالعلم وتجلّ الأدب، حيث دأبت على التميّز في حفظ القرآن بالكتّاب قبل الالتحاق بمقاعد المدرسة. وباكتشاف عوالم الكتاب في سنوات الابتدائي الأولى، تعمّق لديّ الشّغف بالقراءة. ثمّ تحوّل إلى عشق للأدب وولع بالمطالعة مكّناني من الاطّلاع على معظم الأعمال الأدبيّة الكلاسيكيّة والمعاصرة العربيّة والعالميّة باللّغتين العربيّة والفرنسيّة بما جعلني في الدّرجات الأولى سنوات التّعليم الثّانوي في مادّة العربيّة بالخصوص.
إلاّ أنّ ذلك لم يمنعني من المغامرة في المسار الجامعي، باختيار عالم الفنون التشكيليّة والهندسة المعماريّة والتّصميم في المراحل الأولى من التّعليم العالي، ثمّ العمران والتّعميرى والتّراث والآثار في المرحلة الثّالثة. لكن لم أفقد قطّ الشّغف بالمطالعة والكتابة بصفة متواصلة وتكاد تكون يوميّة. وبذلك حافظت على إيقاع السّرد العفويّ للخواطر وتدوين بعض المقتطعات الشّاعريّة العابرة وأحيانا كتابة الشّعر النّثري والملحون والقصص.
لكنّ نقطة التحوّل في الكتابة، كانت سنة 2006، عندما حالفني الحظّ بمحض الصّدفة، لتقديم قصّة »ذاكرة الوجع« في ورشة قراءة بأقدم نادي أدبي في العالم العربي، نادي القصّة »أبو القاسم الشّابي«، حيث نالت إعجاب أعضائه دون تحفّظ خصوصا منهم رئيس النّادي الأستاذ الكاتب »رضوان الكوني« رحمه اللّه وطيّب ثراه، وتمّ نشرها في مجلّة »قصص«. واعتبرت ذلك معيارا طمأنني على سلامة رصيدي اللّغوي بعد الابتعاد عن الأدب لمدّة طويلة. ومنذ ذلك الحين، وقع قبولي ضمن الهيئة المديرة في الانتخابات وواضبت بجديّة على مواكبة حصص القراءة والنّقد بصفة دوريّة لمدّة سنوات قبل نشر كتابي الأوّل.
- كيف كانت تجربتك في عالم الأدب؟
لم تخل تجربتي في عالم الأدب، من الرّهبة والتهيّب أمام هيئة نادي القصّة وروّاده وأساتذة محنّكين في لغة السّرد القصصي والرّوائي والنّقد، رغم اعتراف الجميع بقدراتي في الكتابة والنّقد. لكنّي لم أتمكّن من تخطّي هذه العقبة فانقلبت المعادلة إلى موانع وعوائق نفسيّة كبحت طموحي واستبدّ بي الخوف من أن أخيّب ظنّهم وبقيت قصّة »ذاكرة الوجع« يتيمة. واصلت التدريب على الكتابة بصبر وحرص شديد على توظيف ما أتعلّمه في ورشات القراءة دون أن أتجرّأ على مغامرة النّشر. ولعلّ ذلك ما يفسّر كلّ هذا التّأخير في الإصدار.
ومع ذلك كان لهذا المسار أهميّة كبيرة ساهمت في تحسين المردود السّرديّ لكتاباتي وصقل موهبتي المتواضعة. إذ قدّم لي إفادة نوعيّة في تحفيز الوعي بكتابة القصّة وإتاحة التّمييز بين مكوّنات بنيتها ومنحني فرصة الاطّلاع على المدوّنة الأدبيّة ومراكمة التّجارب التي وفّرت لي إحاطة مكّنتني من إدراك أدوات كتابة القصّة بتأطير من رموز وأعلام السّرد بالبلاد، قبل أن أنحت مسارا خاصّا بي وأسلوبا يشبهني في كتابة القصّة لأدخل مجال النشر.
عندما نضجت هذه التّجربة وتوفّر لديّ رصيد من القصص، يعكس نوعا من الوعي بعمليّة الكتابة القصصيّة، وبتشجيع كبير من أعضاء نادي القصّة الأجلاّء، قرّرت المغامرة. كانت ولادة كتابي الأوّل »عرس القمر« جدّ عسيرة، إذ بقيت نصوصه خمس سنوات تحت المراجعة والتّدقيق وإعادة القراءة يوميّا إلى أن رأى النّور سنة 2022 بدفع من الأديب الدّكتور عبد القادر العليمي. ولعلّ هذا الجهد المبذول كان من الأسباب التي جعلت مجموعتي القصصيّة الأولى، حاليّا في طور إعداد طبعتها الثّالثة بعد نفاذ كامل نسخ الطّبعة الأولى والثّانية.
وبعد خوض محنة النّشر المضنية التي كشفت لي معاناة المبدعين، وللتّرفيه عن النّفس، عدت للمطالعة ألتهم ما يعترضني من الكتب وما ينشر من النّصوص السرديّة القصصيّة والرّوائيّة، إلى أن سقطت صدفة بين يدي، مجموعة »شجرة الأحلام العالية«. ومن فرط إعجابي بأسلوبها الممتع ومضامين نصوصها الهادفة، قمت بنقلها إلى الفرنسيّة تلقائيّا. وبالاتّفاق مع صاحبها تمّ نشرها للمشاركة بها في معرض تونس الدّولي للكتاب سنة 2025.
كانت تجربة التّرجمة، مجازفة محفوفة بالمخاطر. إذ لا تخلو من صعوبات في محاولة إتقان عمليّة النّقل من اللّغة العربيّة إلى الفرنسيّة، خاصّة من حيث المسؤوليّة تجاه الأثر في حدّ ذاته وتأويل المعنى وصدق التّعبير. والأهمّ فيها هو السّعي إلى امتلاك القدرة على سبر أغوار اللّغة العربيّة والوعي بتمثّلاتها ودلالات رموزها من أجل محاولة استقراء مضامينها بأمانة عند إعادة الكتابة بأدوات لغة مغايرة وقواعد سجلاّت ثقافتها وخوصا في المحافظة على دقّة محتوى الرّسائل المضمّنة في النّص الأصلي وضمان تمريرها للقارئ دون تشويه.
- ما هي السّياقات التي تكتبين حولها وهل يشكّل لك الواقع التّونسي خزّانا للتّجارب وأين يظهر ذلك في أعمالك؟
في الحقيقة، أنا لا أختار سياقات الكتابة، لأنّ الفكرة وليدة اللّحظة المعاشة والذّاكرة سيّدة الموقف والخيال يشكّل بينهما عمليّة السّرد فتتقاطع الأحداث بصفة تلقائيّة. قد يكتب كلّ منّا وفق ذائقته الخاصّة، فيختلط الذّاتي بالموضوعي والنّفسي بالفكري والمادّي بالرّوحي. لكن لا يمكن أن نكون منبتّين عن قضايا محيطنا المباشر. وقد يتميّز المبدع عن الفرد العادي، في مدى قدرة الأوّل على ترتيب اختلاجاته بوعي ورسم التمثّلات المشتركة بإضفاء أبعاد فنيّة في مشهديّة مغايرة تمنح المتلقّي مفاتيح قراءتها وفكّ شفرة ألغازها لإدراك دلالاتها.
نعم لقد شكّل الواقع التّونسي وخاصّة سياق العشريّة الأخيرة، خزّانا جدّ ملهم لمعظم القصص سواء في مجموعة »عرس القمر« أو المجموعة القادمة، رغم أنّ بعضها كتب في بداية الألفينيات وتمّت إعادة صياغتها. إذ تنهل مواضيعها من حقائق واقعيّة يطوّح بها التّخييل لربط جسور فكريّة ووجدانيّة تسمح باختراق الموروث المشترك واستحضار أساطير وحكايا وإسقاطها على الواقع لمساءلة المرجعيّات الثقافيّة في مراوحة مع الذّاكرة. فأنا لا أطرح نظريّات جديدة بقدر ما أحاول تشغيل العقل دون تحفّظات، للتوّغل في ذاكرة الفرد وتحفيز وعيه وتعرية الواقع. وبالنّهاية تبقى للقارئ حريّة التّأويل المطلق حسب ثقافته، وعلى المتلقّي وحده أن ينتقي بينها ما يلائمه وفق درجة إدراكه.
طرحت مجموعة »عرس القمر« مواضيع اجتماعيّة وسياسيّة حسّاسة تنهل من الرّاهن بخلق شخصيّات رمزيّة عابرة للزّمان والمكان في ضرب من الكناية والمجاز، لاختراق الذّاكرة والتّعريض بالواقع بأسلوب ممجوج بالألم والسّخرية مثقّل، في أغلب الأحيان، بهواجس الخوف والحلم والتّوق إلى الأفضل والتمرّد على الواقع ومواقف الرّفض والمقاومة والمساءلة الجليّة. وهي كتابة مشحونة لا تخلو من منزلقات خطيرة ربّما لا طاقة للكاتب على تحمّل وزر تبعاتها.
وقد ترجمت تمثّلات السّرد القصصي واقع ما بعد الثّورة الدرامي باستجلاب الذّاكرة للإشارة إلى التحوّلات الجذريّة التي شهدتها البلاد، وتصوير أحداث دامية هزّت الرّأي العامّ. وسلّط القصّ مجهره على الشّأن العامّ لنقل هواجس ذات الفرد والجماعة من خلاله، وتوصيف الحالات النفسيّة والرّوحيّة والتّعبير، من منظور مختلف، عن التصدّعات والشّروخ العميقة التي خاض فيها المجتمع صراعات نفسيّة واجتماعيّة وسياسيّة في علاقة بالخلافات حول المرجعيّات والهويّة.
كما رسمت مشهديّة دراميّة مضحكة لسياق »الرّبيع العربي« وتبعاته في قصّة »حذاء عبد الرّحمان« في علاقة بالتّاريخ والحداثة، وطرحت رؤي دقيقة لتداعيّات الثّورة في قصّة »ذاكرة الخوف«. فضحت عقم توظيف الدّين في قصّة »حيّ على الفلاح«، وأدانت جرم تلطيخ أماكن الذّاكرة بالدمّ في العمليّات الإرهابيّة في قصّة »وسام الحبّ والسّلام«. صوّرت تأثير الأحداث على السّلوكيّات العامّة داخل الإدارة في قصّة »وشاية شهرزاد« وفي المطارات من خلال قصّة »غزالة وتفاهة المسروق« وفي مكاتب الاقتراع في قصّة »على نخبك يا وطن«. كما نقلت بعدسة المثقّف الموجوع، ملحمة شهداء الوطن بالرّفض والتصدّى لتصفية الرّموز الوطنيّة بالاغتيالات السّاسيّة في قصّة »عرس القمر« وهي قصّة مهداة إلى الشّهيد الرّمز »شكري بلعيد«.
- يشكو الكثير من الكتّاب من صعوبات النّشر وقلّة الدّعم وعدم وجود أو وضوح السّياسات الوطنيّة للكتاب، فهل أفلتت من هذه العقبات والمشاكل؟
قد لا يتّسع المجال للخوض في موضوع النّشر والسّياسات الوطنيّة للكتاب، ونحن لا نملك المعطيات الكافية والإحصائيّات الدّقيقة في المجال، والحال أنّها مسألة داخليّة مطروحة بقوّة على السّاحة ومتداولة في الرّأي العامّ بين أصحاب الشّأن والمختصّين سواء من قبل المؤسّسات الوطنيّة والهياكل المعنيّة والمنظّمات المهنيّة ودور النّشر أو من طرف الكتّاب والمفكّرين والمبدعين. لأنّ مسألة الإبداع ليست من مشمولات مؤسّسات الدّولة فحسب، خصوصا أمام الإمكانيّات المتاحة بتوظيف التكنولوجيات والوسائط الحديثة التي أتاحت سرعة التّواصل.
ولعلّه من واجب المهنيّين ومسؤوليّات أهل الاختصاص الملحّة في القطاع، على ضرورة بلورة رؤيتهم الخاصّة أوّلا وإيجاد حلول عمليّة وابتكار تصوّرات جديدة لمعالجة الوضع بعيدا عن المسائل الربحيّة. إلاّ أنّ ذلك لا يجيز لنا عدم الاعتراف بوجود ضغوطات ذاتيّة وأخرى موضوعيّة تحفّ بالقطاع وصعوبات ماديّة يتعرّض لها الكاتب في مرحلة النّشر وعراقيل لوجستيّة وإجرائيّة على مستوى التّوزيع، تعوق انتشار أعماله الأدبيّة وإنتاجاته الفكريّة بالقدر الكافي، ناهيك عن التّعريف به والتّرويج لأثره محليّا وإقليميّا.
وفي ظلّ غياب آليّات التّحفيز والتّشجيع وخاصّة عدم وجود أسواق توزيع إقليميّة جديّة تسهّل تشبيك العلاقات بين الهياكل المهنيّة وتفرض اقتناء الإصدارات الجديدة، لا بدّ لأهل المهنة من التّفكير في تفعيل دور التّعاون المشترك بين الدوّل الشّقيقة لتوظيف الدبلوماسيّة الثقافيّة وفتح جسور أفقيّة بينها لتوزيع الكتاب وإحداث منابر إعلاميّة مختصّة ومكثّفة لكسر الحواجز النمطيّة وربط علاقات مثمرة بين المبدعين تسمح بتبادل التّجارب والاطّلاع عليها والتّرويج لها.
وأمام هذه الصّورة غير المبهجة بالمرّة، فأنا شخصيّا لم أفلت من هذه الدّائرة. ولكن حريّ بنا أن نشير إلى وجود مسالك دعم رسميّة وإن كانت قليلة، ونوافذ للنّور مفتوحة ومنابر ثقافيّة مهتمّة بالجودة ودور نشر جديّة تجلّ الأثر وتحترم الكتّاب وتبذل جهودا كبيرة لترويج المنجز والتّعريف بصاحبه، أخصّ من بينها على سبيل الذّكر لا الحصر، دار الأمينة للنّشر التي تجشّمت عناء التّرويج لكتابي »عرس القمر« بما مكّن من نفاذ الطّبعة الأولى والثّانية، وهي بصدد النّظر في إعداد الطّبعة الثّالثة. كما تمّ ترشيحه لمسابقة وطنيّة أدرج فيها على القائمة النّهائيّة للكتب المشاركة. وهذا في حدّ ذاته تقييم مهمّ للعمل يقوم مقام الجائزة.
ولا يفوتني الحديث عن صعوبة الولوج، بصفة آليّة، إلى النّوادي الأدبيّة والمقاهي الثّقافيّة والملتقيات والمجالس الأدبيّة المعنيّة بالكتاب، التي تكاد تكون في الغالب، قطاعييّة مغلقة وغير مشعّة على عموم المبدعين وتقتصر على روّادها في حدود المركزيّة الإداريّة. فيتطلّب الانخراط فيها والاستفادة من مردوديّتها، بذل جهود خاصّة من الكاتب في إطار تشبيك العلاقات العامّة، وأخرى ماديّة لتغطية نفقات التنقّل والإقامة إذا كانت خارج دائرة العاصمة.
- كيف تروّجين لكتاباتك، هل هناك نوادي ومقاهي أدبيّة، أو شبكات تنشطين فيها؟
بقدر ما أوسم به من جديّة ومثابرة في العمل، والحرص على جودة الأثر شكلا ومضمونا، إلى درجة عدم التّسامح مع ذاتي، سواء بتكثيف عمليّات إعادة القراءة والمراجعة المتواصلة للنّصوص، أو بالاستعانة بكثير من ذوي الخبرة في الإصلاح واستشارتهم، فأنا أعترف بالتّقصير في حقّ نفسي.
وفي المقابل، تلقّيت دعوات تكريم وتقديم كتاب »عرس القمر« للتّعريف به من عديد دور الثّقافة والمكتبات العموميّة والنّوادي الأدبيّة العريقة ذات القيمة الثّابتة في المجال، استفدت من جديّة تعاطيها مع الكتاب وثراء ملاحظات روّادها، على غرار نادي القصّة »أبو القاسم الشّابي« أو بيت السّرد أو اتّحاد الكتّاب أو مجالس الخميس أو النّوادي الثقافيّة أو المكتبات العموميّة أو دور الشّباب وغيرها من الفضاءات الثقافيّة.
قد يبدو هذا الكمّ من الدّعوات واللّقاءات الأدبيّة، كافيا للتّعريف بالمبدعين وإنتاجاتهم، إلاّ أنّه على أهميّتها وأمام غياب مجالس النّقد بمختلف مدارسه وحلقات القراءة الأدبيّة والحوارات الجديّة وورشات السّرد، لا يمكن للقطاع أن ينهض وينتعش الإنتاج وينعم المبدعون. كما أنّ وسائل الاتّصال المحترفة، مثل القنوات التلفزيّة والإذاعيّة والصّحف على قلّتها، والمواقع والرّقميّة لا تواكب هذه المنابر لتغطيتها إعلاميّا وتقريبها من المواطن. وبهذه الطّريقة أخشى أن يبقى عالم الأدب منعزلا عن الحياة العامّة.
- ماذا عن الإعلام الثّقافي، هل هو مرافق دائما لك أم لديك بدائل؟
قد أقسو على الإعلام الثّقافي الذي يبدو غير منشغل سوى بالفنون الصّوتيّة المستساغة وسهلة الاستهلاك مثل الانتاح الموسيقي والغنائي وفنون العرض في المسارح والمهرجانات والتّظاهرات الموسميّة والأنشطة الثقافيّة الرسميّة، أكثر من اهتمامه الإبداع الأدبي والفكري. إلاّ أنّ الواقع قد فرض هذا الوضع في خضمّ التحوّلات التكنولوجيّة التي تشهدها مختلف الشّعوب وانفتاح العالم على مصادر المعلومات. كما أنّ انفلات الوسائط الحديثة وهجوم الذّكاء الاصطناعي كلّ ذلك أثّر بعمق على طريقة التّعاطي مع الكتاب التّقليدي.
ولعلّ زخم المادّة الإعلاميّة المتوفّرة وسرعة تدفّقها بكميّات مهولة، من هنا وهناك دون تكبّد عناء اقتناء كتاب وقراءته لصياغة مقال ما، يدعونا إلى إعادة النّظر في منظومة صناعة الكتاب وخاصّة إعادة تهيئة الفضاءات الثقافيّة المعنيّة بالكتاب وتحديث أجهزتها بما يتطابق مع متطلّبات العصر وتغيير أدوات التّواصل الكلاسيكيّة المعتمدة بمفردات العصر خاصّة أمام تراجع قيمة الكتاب وكلّ ما هو ورقي خاصّة مع تغيّر أدوات التّواصل ومفرداته.
ربّما من أكبر أخطائي، أنّي كنت قد آليت على نفسي الإتزام بالتّواضع، بشكل مبالغ فيه، وتعفّفت عن التلهّف وراء الإشهار لشخصي والتّرويج لإنتاجي حتّى على شبكة التّواصل الاجتماعي. وهي بالنّسبة لي، مسألة مبدئيّة إيمانا منّي بأنّ دور الكاتب ينتهي عند إصدار الأثر ليبقى يتابع ردود فعل القرّاء ورجع صدى النّقد. وبقدر ما يبتعد شخص الكاتب عن مسألة التّرويج بقدر ما يكسبه ذلك بعد نظر ويمنحه مسافة من الأثر الذي لم يعد ملكا له. إذ يعتبر التّرويج نوعا من الإشهار الذي لا يكتسي صبغة موضوعيّة بل هو مغرق في المسائل الذّاتيّة بما قد يضرّ الأثر وينفخ في صورة الكاتب دون عمق.
وأعتقد أنّ التّرويج للكتاب يجب أن يبقى من مهامّ الهياكل المهنيّة الثقافيّة والأدبيّة المعنيّة بالكتاب ودور النّشر ووسائل الإعلام، في إطار سياسة عامّة ترسم خطّة إعلاميّة شاملة لمنظومة تعنى بصناعة الكتاب التي لا بدّ أن تخضع ضرورة إلى معايير فنيّة وتقييمات أكاديميّة حتّى لا تنفلت الأمور، دون أن يكون للنّقد دور وللجامعة قول وللمختصّين وأهل الذّكر رأي. فالبدائل الحقيقيّة للتّرويج هي تفعيل مدارس النّقد وتكثيفها مع المصاحبة الإعلاميّة للنّهوض بالأدب والارتقاء به إلى مصافّ الإبداع الإنساني.
- هل لك مشاركات وتشبيك مع أدباء، جمعيّات أدبيّة، ملتقيات من شمال إفريقيا؟
للأسف أن أقرّ بالنّفي في هذه المسألة. مغ أنّ شعوب مجتمعات منطقة شمال إفريقيا، بخلاف مناطق أخرى، لها إرث ثقافي وحضاري متشابه يكاد يكون متطابقا، وروابط تاريخيّة مشتركة وطيدة. وأمام تقارب الموقع الجغرافي، كان من المفروض إحداث جسور تبادل بين المبدعين ونسج علاقات أكثر نجاعة خصوصا في مجال الكتاب والثّقافة والإبداع عموما. ورغم ذلك أخجل أن أقول أنّه لم يسعفني الحظّ للتّواصل مع بعض الكتّاب والأدباء أو جمعيّات أدبيّة من شمال إفريقيا سواء لتبادل التّجارب فيما بيننا أو للمشاركة في ملتقيات من هذا النّوع.
قد يعود ذلك إلى غياب الرّوابط المهنيّة وآليّات التّواصل في المجال، وقد ألوم نفسي في هذه الحالة قبل أن ألقي المسؤوليّة على غيري لأنّي لم أسع لذلك مع أنّه لي كلّ الاستعداد لتلافي هذا النّقص بربط علاقات ثقافيّة وأدبيّة للتبادل الإيجابي وإثراء تجربتي. وكم وددت أن أطّلع على بعض أعمال أشقّائنا في القصّة والرّواية والشّعر وحتّى في مختلف الإنتاجات الفكريّة والدّراسات العلميّة.
- كيف تنظرين لمستويات الكتابة في بلدان شمال إفريقيا، من حيث البناء اللّغوي والمخيال وتقنيّات السّرد؟
رغم قلّة اطّلاعي على الأعمال الحديثة لهذه البلدان، باستثناء الإنتاجات الكلاسيكيّة المعروفة التي سمحت لنا المناهج التربويّة بالتعرّف عليه خلال المسار المدرسي والجامعي، وبالنّظر إلى أدوات الكتابة التي توظّف اللّغة العربيّة كقاسم مشترك في المطلق، فلا بدّ أن يكون هناك بالضّرورة تقارب في الذّائقة والثّقافة والعادات والتّقاليد. كما أنّ مستويات اللّغة لا تتجلّى سوى بوعي الكاتب أثناء توظيفها وقدرته على صياغة مفرداتها بشكل يضفي عمقا على المعنى.
وبالنّزر إلى أنّ المخيال المحرّك الأساسي لجهاز الذّاكرة، فلا يمكننا أن نتصوّر، إلى أيّ مدى يمكن للتّخييل أن يطوّح بالمتلقّي من خلال إعادة تركيبه للمجازات المضمّنة في الأثر. لذلك يعمد المبدع المحنّك إلى دسّ مفردات مفاتيح تتيح تفكيك الرّموذ في ذهن المتلقّي واستكشاف دلالاتها وفكّ شفرتها وتأويلها من خلال رجع صدى السّرد في تمثّلات الفرد والجماعة وبالتّالي إدراك الرّسائل.
لذلك أنا لا أتصوّر أن يكون هناك اختلاف كبير بين مبدعي هذه المجتمعات، سوى في قدرة كلّ منهم على التّلاعب في ترتيب تقنيّات السّرد والتفرّد بأسلوب الإدهاش لخلق مشهديّات إبداعيّة تشدّ انتباهنا. كما أنّ الخصوصيّات الذّاتيّة والمحليّة لكلّ من هذه البلدان، يمكنها أن تحقّق التّمايز وتخلق مادّة الإبداع كما هو الشّأن بين مبدع وآخر من نفس البلد. والإبداع في النّهاية هو لغة الإنسانيّة في كلّ زمان ومكان، فما بالك في مجتمعات لها أكثر من مرجعيّة مشتركة.
.jpeg)
 سبت, 06 سبتمبر 2025
سبت, 06 سبتمبر 2025 
 سبت, 06 سبتمبر 2025
سبت, 06 سبتمبر 2025 
 جمعة, 08 أكتوبر 2021
جمعة, 08 أكتوبر 2021 
 ثلاثاء, 22 يونيو 2021
ثلاثاء, 22 يونيو 2021 
 سبت, 18 سبتمبر 2021
سبت, 18 سبتمبر 2021 
 جمعة, 01 أكتوبر 2021
جمعة, 01 أكتوبر 2021 
 ثلاثاء, 02 نوفمبر 2021
ثلاثاء, 02 نوفمبر 2021 
 اثنين, 18 أغسطس 2025
اثنين, 18 أغسطس 2025 




 تابعنا على تليجرام
تابعنا على تليجرام  تابعنا على واتساب
تابعنا على واتساب